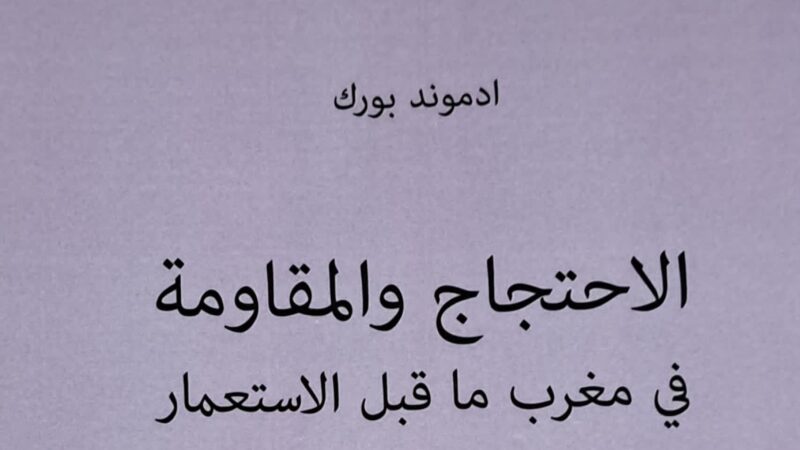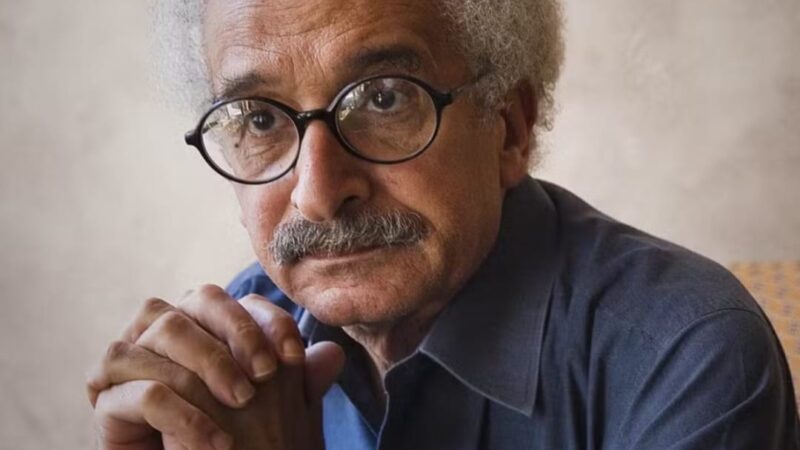مختبر السيميائيات بالدار البيضاء يفتتح لقاءاته العلمية بمحاضرة « البلاغة والتأويل »

محسن الزكري يبسط ويناقش التصورات الفلسفية للبلاغة والتأويل
رقية منظور
يوسف الخيدر
في اللقاء الذي أداره عبد العالي معزوز، بحضور مدير المختبر عبد اللطيف محفوظ، والطلبة الباحثين، أكد محسن الزكري، إن « تاريخ البلاغة يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وهي قديمة قدم الإنسان، ظهرت كممارسة، وليس كفن أو نظرية، أو مجال معرفي ».
وكشف محسن الزكري، في محاضرته، بعنوان « البلاغة والتأويل: تصورات فلسفية » ، يوم الجمعة الماضي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن « البلاغة بالنسبة لغدامير هي التي تخلق الأفق الرحب للحوار، وأن حوار اليوم يجب أن يكون بلاغيا على نحو يجعل من البلاغة أفقا لتداول الكلام من جهة، وأفقا للابتعاد عن الدوغمائيات، وهي الخلاصة التي وصل إليها بعد نضوج فكره الفلسفي، في السنوات المتأخرة من عمره ».
وأوضح الزكري وجود تباين يميز البلاغة والتأويل، كمجالين معرفيين، متسائلا عن « العلاقة والأواصر التي يمكن أن تجمع بينهما؟ ».
وفي هذا الصدد، استحضر مؤلف كتاب « أصول التأويل في البلاغة العربية »، مقولة لجون غروندان، التي يقول فيها: « إن أفق كل تفكير اليوم يروم أن يتخذ طابعا كليا، وطابعا كونيا، لا يمكن أن ينفصل عن كونيته، أي كونية التأويليات، وكونية البلاغة »، مشيرا إلى أن « سؤال الكونية هو سؤال فلسفي قديم لكنه معاصر اليوم كذلك ».
وذكر المتحدث ذاته، بأن هناك مجموعة من الإجابات حول سؤال الكونية، من بينها أطروحة التواصل لدى لوسيير، باعتباره الأفق (التواصل) الذي يمكن أن يغذي المعرفة الكونية، ثم هناك البلاغة والتأويليات بالنسبة لجون غروندان، ثم أيضا كونية الترجمة عند الفيلسوف سليماني..

الإرهاصات الأولى
والمتأمل لتاريخ الفلسفة وتاريخ البلاغة، سيكتشف أن « الإرهاصات الأولى بدأت في المرحلة اليونانية والرومانية، مع أنه في المرحلة اليونانية كان الأمر غير واضح، لكن في المرحلة الرومانية مع القديس أوغوسطين بدت الفكرة واضحة جدا »، بحسب محسن الزكري.
وبشأن الفترة اليونانية، أشار الزكري، إلى أن مصطلح « البلاغة » باللغة العربية، هو ترجمة لـ »ريتوريكا » (Ῥητορική) باللغة اليونانية، منبها إلى أن هذه الترجمة غير دقيقة، ولهذا السبب كان المترجمون العرب القدامى يفضلون استعمال كلمة « ريتوريا ».
وأفاد المحاضر، بأن البلاغة عند اليونانيين، هي « صانعة الإقناع »، محيلا على تعريف أرسطو الذي حدد البلاغة بـ: « الشرط الممكن للإقناع في أي موضوع »، وهو ما يدل على أن الثابت في البلاغة اليونانية هو « مسألة الإقناع ».
ويرى بأن: « الإقناع هو تلك الرغبة التي تحذو المتكلم، وهو يريد أن يقنع ويخاطب المخاطب »، لكن هناك أيضا « الجانب المتعلق بالتلقي، من حيث أشكال الحجج، وطرق اكتشافها، والتي عندها نكون بصدد ممارسة تأويلية ».
وزاد محسن الزكري مفسرا في مداخلته، بأن المهم في هذه المسألة، هو أن « البلاغة تعنى بالأساس بجانب الإنتاج، والتأويل يختص بجانب التلقي، وهو ما كان قد نبه إليه شلايرماخر ».
ورصد الزكري وجود أواصر العلاقة بين البلاغة والتأويليات في الفترة اليونانية، عند كلمة هرمينيا بالتحديد، وكذلك مصطلح هيرمينوس، والتي تعني رسول الآلهة، وهو ذلك الرسول الذي ينقل المعرفة من الآلهة ليوصلها إلى الإنسان، مؤكدا أن « فعل ذلك هو فعل هرمينوطيقي أي تأويلي، بحيث كان يستمع إلى المعنى الإلهي ويتأمله ويترجمه على نحو بشري، وهي التي تشكل البعد الهرمينوطيقي أو التأويلي لهذه العلاقة، ما يدل على أن عملية نقل الكلام الإلهي إلى البشري، هو فعل لإنتاج اللغة، وهو فعل بلاغي ».
وتصبح كلمة هرمينيا قريبة من « الجدل » في المعجم الأفلاطوني، بيد أنها تعني « التعبير والتواصل » في المعجم الأرسطي ».
وانتقل محسن الزكري، إلى التداول في « البلاغة والتأويل » خلال المرحلة الرومانية، خصوصا لدى القديس أوغوسطين، باعتباره من أعاد اللغة إلى حضن التفكير الفلسفي، وأرجع إليها أهميتها لجعلها قادرة على المساهمة في الإبداع الفلسفي، بعدما كانت نزعة اسمية في الثقافية اليونانية، وهو ما يطلق عليه غدامير بـ »نسيان اللغة في الفكر الغربي ».
وشدد المحاضر، على أن أوغوسطين، أعاد للغة وهجها في المرحلة الرومانية، وهو ما وقف عنده تودوروف، وهو ينظر للتاريخ السيميائي، قائلا: « إن المؤسس الأول لهذا المجال المعرفي، هو أوغوسطين »، على اعتبار هذا التأسيس تحقق نتيجة إدماج البلاغة في صلب التأويليات.
وأوضح بأن هذا الإدماج « تحقق بفضل التطبيق في مستويات معنى الكتاب المقدس، والاهتمام بالتراث البلاغي، قصد التمييز بين معاني الإنجيل، خصوصا التمييز بين المعنى الظاهر والخفي والمجازي ».
ظهور المطبعة
وعرج محسن الزكري على المرحلة البروتستانية، التي تميزت بظهور المطبعة، وهو ما ساهم في نشاط العلاقة بين التأويليات والبلاغة، ذلك، أن المطبعة ساهمت في انتشار الممارسة التأويلية، بظهور محاولات لتأويل الكتاب المقدس، بعدما كانت عملية التأويل محصورة لدى نخبة محددة فقط.
ويعد ميلانكتون، من بين من شرحوا الكتاب المقدس، مستندا إلى البلاغة في قراءته وتحليله، وذلك ضمن المحاولات الرامية إلى إضفاء الطابع البشري على التأويل، من خلال ما تجود به الذخيرة المعرفية، أو ما يسميه أمبرتو إيكو بـ « الموسوعة »، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، عاد ميلانكتون إلى الخطابة الأرسطية لكي يتأمل الكتاب المقدس، في محاولة إلى استكشاف التقاليد التي كانت راسخة في العصور القديمة لفهم النصوص، وهي ما يسميها غدامير بـ »محاولة تقليص المسافة بين أزمنة الإنتاج وأزمنة التلقي ».
وانتقل محسن الزكري إلى تقديم فلسفة بيكو البلاغية، باعتباره أعطى للبلاغة بعدا آخر، موظفا إياها في تأويل التاريخ، « وهذا الاستعمال هو فريد من نوعه في تاريخ العلاقة بين البلاغة والتأويل ».
وأشار الزكري إلى أن بيكو يقسم التاريخ إلى ثلاثة عصور، أولا؛ العصر الأسطوري، ثانيا؛ العصر البطولي، وثالثا؛ العصر العامي. والعصر الأول ينبع عنه الطابع الاستعاري (الاستعارة/ الأسطورة) بمعنى أن الإنسان لم يكن قادرا على التمييز بين الأشياء وبين الذات والموضوع، والثاني الطابع الكنائي (الكناية) عرف بسيادة الدين، والطابع الثالث الوصفي (الوصف)، ساد فيه العلم.
من جانبه، يميز رولان بارث بين البلاغة الأرسطية التي شكلت التقعيد الكلاسيكي لفكرة البلاغة والهدف منها هو « الإقناع »، وكذا البلاغة الأفلاطونية التي تتمثل في تطرق متحاوران إلى موضوع معين يكونان فيه على طرفي نقيض، إلا أنهما يتعاونان بهدف الوصول إلى معرفة مشتركة، ويميز بين البلاغة السوفسطائية التي كانت غير أخلاقية نوعا ما، لأنها كانت تضلل وتمارس الحيل اللغوية، قصد إقناع الآخر بالرأي، بدون أن يؤدي بالضرورة إلى حقيقة.
ولم تفت محسن الزكري مناسبة الحديث عن البلاغة والتأويل، بدون طرح تصور نيتشه في الموضوع، والذي يعود إلى سنة 1872، مفردا مساحة مهمة للبلاغة، لاسيما فيما يتعلق بقدرة المجاز والاستعارة على توليد الأفكار والمعارف التي تتيح لنا فسحة من التنوع لا يتحيها التأمل العقلي، ذلك، أن قدرة الاستعارة على بناء الحقائق هي التي تشكل بالنسبة إليه هاجسا، والتي دفعته إلى أن يبحث في هذا المجال المعرفي وهي الاستعارة التصورية.
جدير بالذكر، أن اللقاء العلمي ذاته، شهد تقديم الطالب الباحث عادل بنملوك عرضا حول « الفيلولوجيا مدخلا للتأويل الفلسفي عند نيتشه »، وهو بمثابة تقرير حول ما وصل إليه الباحث في أطروحته التي يشتغل عليها، حول فلسفة نيتشه.
وتكمن أهمية البحث في هذا الموضوع وفق عادل بنملوك، في كون الفيلولوجيا مفتاحا مهما في التأويل الفلسفي عند نيتشه، مؤكدا أنه أينما وجدت الفيلولوجيا توجد الفلسفة، وهو ما يواصل البحث فيه بنملوك، بالرغم من الصعوبات التي تعترضه وهو ينقب في الموضوع.