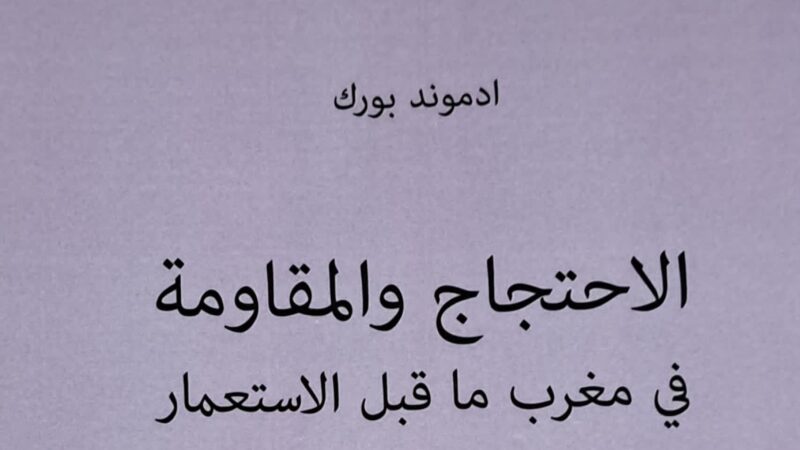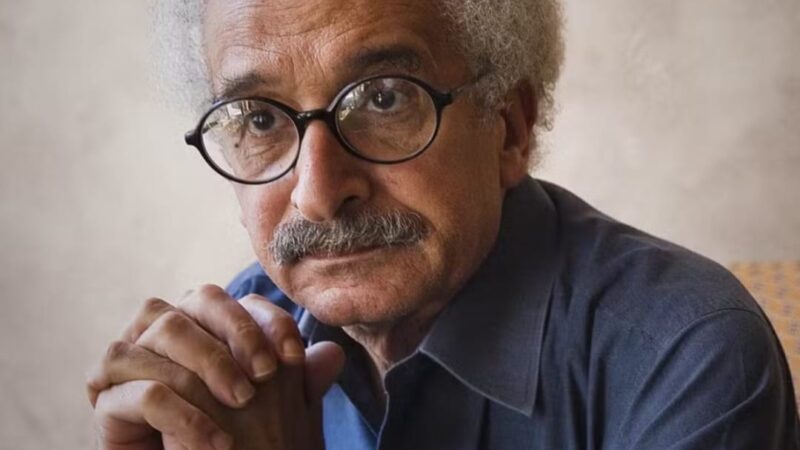عشق

يكتبها لكم شيخ القاصين عبد الحميد الغرباوي
صدق من قال:
« إن النافذة أقدم وسيلة اتصال ابتكرها الإنسان. »
غرفتي تشكل مع غرفة أخرى وصالون مربع ومطبخ وحمام شقة صغيرة، في الطابق الثالث من عمارة بنيت في أواخر الخمسينات من القرن العشرين، تقع بشارع عريض وطويل ينتهي بساحة يتوسطها دوّار يسمح للآلات المتحركة بالانعطاف يمينا في اتجاه الحديقة العمومية التي هي الأخرى تعود نشأتها إلى نفس فترة بناء العمارة تقريبا.. يقال إن العمارة كانت في ملكية فرنسي يهودي..
الأمر المثير للتساؤل وكذا للاستغراب، أن شقتي لها نافذة واحدة.. وهي نافذة غرفتي..
و منذ أن أصبت بشلل نصفي مفاجئ، أصبحت حبيس جدرانها، ولم يعد يربطني بالعالم الخارجي سوى النافذة.. هذه النافذة..
ثمة أناس أعرفهم بحكم العادة..
أعرف أوقات ظهورهم وأوقات غيابهم..
و أعرف حتى شكل ملابسهم والألوان المفضلة لديهم، وطريقة مشيهم وتحريك الرأس..
بعضهم يسكن بالشارع، و آخرون يعملون به..
فمثلا، في حدود التاسعة صباحا، بعد أن أكون، قبلها بقليل، قد فتحت النافذة لاستقبال أول حزمة من هواء يحمل رائحة البحر الذي لا يبعد عن المنطقة كثيرا، ليس نقيا بالتمام، لكنه يتيح لي ولشقتي فرصة الانتعاش برائحته وبرودته..
في هذه الساعة، يمر شخص يرتدي بذلة أنيقة رمادية، في بعض المرات تكون سوداء، تتدلى من يده محفظة جلدية بنية اللون، يتقدم نحو مدخل العمارة، المقابلة لنافذتي، يغيب داخلها، ثم يظهر، بعد دقائق، خارجا يحمل بذلة المحامي، ويغيب سريعا وسط المارة..
و في حدود العاشرة ونصف تقريبا تبدأ قطط قادمة من كل حدب وصوب في التجمع جوار متجر مغلق من زمان، كما لو أنها على موعد هام.. وما أن تمضي دقيقة أو دقيقتين، حتى تظهر امرأة مسنة تقبل نحوها تحمل كيسا من بلاستيك فتتجمع حولها، بعضها يتمسح بساقيها مصدرة مواء رقيقا، ولا تنتظر كثيرا، إذ سرعان ما تستجيب المسنة لموائها فتفتح الكيس وتوزع محتواه على القطط التي تنقسم إلى مجموعات وتشرع في الأكل تحت مراقبتها..
في ذات الوقت، تظهر الطبيبة جارتي في العمارة » مدام ليلى « ، تركن سيارتها الصغيرة، جنب الرصيف المقابل، ثم تقطع الطريق حذرة وتدخل عيادتها..
إنها طبيبتي المشرفة على علاجي. مختصة في الترويض الطبي. من حسن حظي أن عيادتها تقع في الطابق الثالث جواري. تتمتع بأناقة ورقة و تتقن عملها، كما أن مساعداتها لا يعدمن أناقة ورقة..
أشعر بارتياح كبير، فأصابع قدمي بدأت تستجيب للعلاج وبدأت تتحرك.. تتحرك ببطء شديد، لكن أحسن مما كانت عليه قبل الخضوع لحصص العلاج..
أتساءل عن سبب استجابة أصابع قدمي اليسرى للعلاج قبل أصابع قدمي اليمنى..
و أقول دائما: سأستفسر الطبية مدام ليلى في الأمر، لكني لا أفعل..ربما خوفا من أن أتلقى تفسيرا مزعجا، لا يطمئنني..
و بعد ذلك بقليل، يدخل الشارع رجل أربعيني، عريض المنكبين، يبدو في أوج قوته، يدفع عربة يحرص على أن تكون نظيفة، لا تثير تقزز الساكنة، معلنا عن مجيئه بواسطة نداءات يستعرض من خلالها ما جلبه إليها من خضار وفواكه الموسم..
قبل الثامنة، حين تكون النافذة مغلقة، والشارع يكاد يكون خاليا إلا من بعض السابلة ، يتناهى إليّ صوت زمور سيارة، و أعرف أنها سيارة نقل الأطفال إلى المدرسة.. أطفال العمارات قليلون، ونادرا ما يتجمعون أسفلها محدثين صخبا وضجيجا..
يستحيل أن أتصور جدران بناية بلا نوافذ..
حتما سيكون مظهرها الخارجي كوجه مشوه بلا عينين..
من شهر، تقريبا، اعتدت رؤية فتاة سمراء تعرض ورودها على الرصيف المقابل، حتى صرت أعتبر حضورها موعدا تضربه معي، يشبه مواعيد العشاق..
بفضلها صار لي موعد محدد مع المسافة،
مع الزمن،
وصار لدي اعتقاد بأن العالم الخارجي في غيابها لا يعني لي شيئا..
ليس سوى فراغ وصمت ثقيل..
كنت أراها كل مساء عندما تغلق المتاجر أبوابها، تضع طاولة مطوية صغيرة، خفيفة الحمل، على الرصيف المقابل لتعرض عليها ورودا للمارين والمارات..
و كلما أراها، أتمنى لو تحدث معجزة فيرفع الشلل عني حمله الثقيل وأسرع نازلا من الطابق الثالث لأساعدها في تصفيف باقات الورد على الطاولة، ثم أعود إلى شقتي وأواصل تأملها من النافذة وهي تقف خلف ورودها، لا تفارق البسمة ثغرها..
وجهها، وحده، أراه متوهجا وسط وجوه مطفأة، بلا ملامح.. عبارة عن أشباح..
فأتساءل عما إذا كانت سعيدة..
و إذا كانت غير سعيدة، فمن أين تستمد كل هذه الحيوية لتبتسم في وجه العابرين..
أن تبتسم في وجه الناس لا يعني بالضرورة أنك سعيد..
ما الذي بمقدوري، أنا الكسيح، أن أفعله كي تكون حقيقة سعيدة؟..
***
مر اليوم على غيابها اثنا عشر يوما..
أين غابت !..
ما الذي قد يكون حدث لها !..
ريح تعربد في الخارج..
هل أترك النافذة مفتوحة؟